
مع هذا الصباح المبكر مضيت إلى لا اتجاه …
كل ما رغبته أن تتحرك بي السيارة ، و أرقب من نافذتها الأماكن التي أعرف و التي لا أعرف ، أشيع بنظرة صامتة القديم الذي مضى ، و أصافح بعين لا تحمل شعور محدد الجديد الذي أتى .
عبرت مباني أنتظرت أمامها أشخاصاً و لم يحضرون ، مطاعم كانت في أوجها حين دخلتها و الآن يرتعش في عنوانها – و منذ وقت – ضوء النيون ، تجاوزت مقهى جلست به وحدي في أنتظار غائباً لا يأتي .
تكدست في طريقي ذكريات لم أحب لها أن تطيل ، لا سيما و أن فكرة الخروج كانت لأجل كسر الرتابة حتى و إن كانت نمط و أسلوب تفكير ، في زاوية لمحت مبنى قديم لكنه لم يزل قادراً على ملامسة قلبي ، و أرى في أطلاله ذكريات و زمن جميل .

كانت الساعة تشير إلى السابعة و النصف صباحاً ، سألت الحارس الواقف على الباب عن إمكانية الدخول ، أجاب الباب مفتوح و لكن أغلب المحلات لم تفتح بعد .
صعدت الدرج الرمادي باتجاه البوابة رقم واحد ، المطلة على موقف سيارات كنا نراه في ذلك الوقت كبير، لم أشاهد المحلات الموجودة أمامي ، بل الاماكن الكائنة بداخلي ، على يسار البوابة فرع حديث و كبير لمكتبة جرير ، أشتريت منه طوابع مغلفة مع دفاتر خاصة بها، في محاولة مني لمحاكاة هواية بعض زملاء الدراسة ، و قد كنت انتقيها وفقاً للشكل الذي يعجبني لا قيمتها أو ندرتها كالآخرين .

في هذا الفرع كنت أحب قسم المجلات المتنوعة إضافة لقسم الكتب ، و اذكر تماما أني اشتريت أول مجلد شعري للراحل غازي القصيبي من هناك ، لكني ندمت بعدها لكونه اقتص جزء من المبلغ الذي معي ، و لم اندمج فعلياً معه في ذلك العمر الصغير أو أهتم بما كتب بداخله ، لكني أحببت شكله لذا اشتريته فحسب !

على يمين البوابة محل “فرسان” الذي كان يقدم أفضل و أجود أنواع اللحوم ، يقطعها بحرص وفق الطبق الذي تريد طهيه و يلفها بعناية ، مرشحاً لك بعض انواع الصلصات التي يعدونها لديهم لأجل التتبيل قبل الشواء أو أضافة النكهة ، هذا الفرع أغلق أبوابه مبكراً و فضل الانتقال لمكان آخر .

دخلت المجمع التجاري الذي أحدث ضجة عند افتتاحه في الرياض ، كان هادئاً ، لا لأن الوقت مبكر بل لأنه بات كذلك ، فالوقت حين يمضي يُبدل ، و يأخذ معه أشياء كثيرة ، من الصعب استرجاعها ، لكن ليس من الصعب تذكرها و تذكر كافة تفاصيلها .
اذكر أن المحلات التي كانت تعني لي في العقارية بتلك الفترة العمرية قليلة ، لكن تظل هناك محلات اذكرها لكوني ذهبت اليها مع والدي أو والدتي .

من تلك المحلات اذكر محل “شمسان” الذي كان يهتم بكل ما هو حديث و عصري ، فتجد لديه العديد من الأدوات الكهربائية المنتقاة و الكاميرات ، و قد كان محل أبي المفضل هناك ، و كان هو ايضاً من زبائنهم المفضلين ، فالعلاقة التي بينه و بين العاملين هناك تجاوزت فكرة الشاري و البائع ، و أخذت منحى إنساني في مناخ كان أبي قادراً على خلقه و ايجاده بينه و بين من يتعامل معهم .

ذات مرة ذهبت لهم ، أنتقيت و أشتريت دون أن أدفع ريال واحد، نظراً لأن أبي اتصل بهم و أخبرهم عن رغبتي بشئ معين و سيدفع لاحقاً .
كان هذا الشئ ” فلاتر ” لعدسة كاميرا أعطاها لي ، تمنح السماء لون الغروب في عز النهار ، أو تعطي إنعكاسات للصور أو لمعان للضوء ، و تجعل من الوجه الكائن أمام العدسة متلألئ و كأنه في حلم ، أذكر يومها بأني حملت هذه الفلاتر المجانية سعيداً ، لا بها بل بالمعاملة فقد أصر البائع على أنها هدية المحل لأبي و لي ، و لم تُسجل و لم يستخرج بها فاتورة.

على بُعد خطوات اخرى يأتي الدرج الكهربائي ، واحد للصعود و آخر للنزول ، بينهما درج رمادي عادي ، عريض و متسع .
على يمين جهة الصعود كان يوجد متجر ” المتحف الوطني ” الذي كان يبيع التحف و الأواني الكريستالية و الفضية و المزينة بما هو مذهب و مزخرف .

في تلك الحقبة الزمنية ( الثمانينات ) كان لهذه السلع رواجاً ، و كانت الظروف المعيشية وفقاً للطفرة الاقتصادية التي حدثت أكثر من جيده ، فكان الانسان قادراً على التماهي و التقليد و المحكاة و اكرام نفسه بشراء هذا الصحن أو ذاك ، و أحياناً كان يقتنيها لا حباً في هذه الأشياء بل ليكون بيته كبيوت الآخرين !

اتذكر أنه من المحلات التي كانت تدخلها والدتي لتتابع ما هو جديد و تراه ، لكنها كانت تشتري هذا النوع من المقتنيات من محلات “العبدالوهاب” لا منه ، لذا لا أملك الكثير من الذكريات عنه ، بقدر ما أتذكره كأسم متداول و متكرر و مكتوب بشكل واضح قرب الجدار الموازي للدرج الكهربائي .

عند الصعود كانت الأشياء الكريستالية تتراقص تحت الضوء من خلف النوافذ الزجاجية ، فأرقبها و أنا أبتعد عنها صعوداً مع والدتي فأذكر بغتة أفلام ديزني ، حيث كانت تظهر ألوان قوس قزح فأراها من بُعد كشئ مميز و جميل .

بعد الصعود و حين تتجه يميناً ستجد “أسواق حسام” ، و هو من الأماكن التي كانت تأتي بمجموعة منتقاة من البضائع المختلفة و المستوردة من الخارج و تضعها معاً، لينتقي المشتري منها ما يناسب ذائقته و يلبي احتياجه .
ما جعل أسم المحل عالقاً في ذاكرتي حديث بعض الأقارب عنه ، لم يكن حديثاً مسترسل بقدر ما كانت اشارة له فحسب ، ” انظري هذا هو المحل الذي سمي على أسم حسام .. الخ ” .
كان أسم المحل على أسم فتى لم يزل يتلقي تعليمه معنا في “مدارس الرياض” ، و صدقاً لا اذكر تفاصيل بقدر ما اذكر اسم المحل و اللون الأخضر الذي كتب به .

على اليسار يوجد محل أحبه ، أسمه “المرسم” ، له أرضية خشبية و تخصص فقط في بيع أدوات الفن و الرسم .
مرة وجدت لديه نوع من أنواع الأقلام الفولوماستر المخصصة للتلوين ، كل لون يباع على حده و بشكل منفصل ، كان السعر مبالغ فيه بعض الشئ وذلك لأختلافها ، فرأس القلم كان كما الريشة في الألوان المائية ، تضربه على الورق فيلون بشكل انسيابي و ناعم .
مضيت سريعاً إلى والدتي التي كانت في محل قربه ، بعد الحاح استطعت اقناعها أن تشتري لي مجموعة كبيرة كنت قد انتقيتها سلفاً ، دفعت و هي تقول بتهكم ” يلا بكره نشوف الرسومات ” ، مما دفع البائع إلى أن يبتسم فأبتسمت معه لأني ببساطة ممتناً لها .

حين تستدير للخلف ستجد في آخر الممر على الزواية متجراً صغير اسمه ” أديم ” ، كنا نذهب إليه مع أمي و خالاتي أول العام الدراسي لشراء المريول المدرسي .
كان متخصصاً ببيع الملابس الرسمية لمدرستنا الأهلية “مدارس الرياض ” ، ذلك الزي المكون من اللونين الازرق و الأبيض .

كانت المرحلة المتوسطة و الثانوية يرتدون تنورة زرقاء طويلة و كانت كل فتاة تختار التفصيل الذي يناسبها – و للدقة الامهات كن يفعلن ذلك – بينما المرحلة الابتدائيه كان المريول اقرب إلى فستان أزرق مقصوص الأكمام ، و يرتدي تحته قميص مخطط بالابيض و الأزرق و هو القميص ذاته الذي يرتدي ايضا في باقي المراحل .

أسعدني اليوم أن هذا المحل تمدد و كبر ، و أخذ المحلات التي بجواره و بات يغطي بخدماته التي يقدم العديد من المدارس ، فرحت بذلك و أعتبرته ومضة أمل ، فرغم توقف محلات عديدة داخل المجمع و خروجها ، ظل هو باقياً و قادراً على التوسع و بشكل مستمر ، مما يحقق توازن مهم يتوافق مع طبيعة الكون و الحياة .

في الضفة المقابلة له أفتتحت منطقة بها عدد محدود من الطاولات و المطاعم ، لا أذكر بأنها كانت موجوده في فترة طفولتي ، فكل ما كان موجود محلات صغيرة تقدم مشروبات ساخنة في أكواب ورقية ، و أغلب روادها كانوا من العاملين هنا ، كما أذكر محل – لم اتمكن من تحديد موقعه – كان يستقبلك عند الصعود برائحة الفيشار الذي كان يباع في أكياس ورقية حينها .

سرت عائداً للدرج و اثناء السير تذكرت الجسر المؤدي لمبنى العقارية رقم ٢ الذي افتتح لاحقاً ، في ذاك الجسر كان يوجد رسامين من شرق اسيا ، كوريا و الفلبين ، يصفون لوحاتهم على امتداد الممر ، بعضها كان يُرسم على مخمل اسود ، و يصور وجوه فتيات تحتل منتصف السماء ، بالقرب من ضوء القمر ، و قد غطوا نصف وجوههن فحسب ، لتظهر شفاه ممتلئة و وردية من تحت طرحة شفافه ، بينما يرسم في الأسفل بيوت الشعر ( نوع من الخيام ) و النار والحطب و رجال البادية ، و قد تم استخدام هذا النوع من اللوح في أغلفة بعض الكتب لاحقاً .

مضيت للجسر و عيناي ترقب عبر الفتحات المطلة الدور الأرضي ، تسترجع ذاك الضجيج و تلك الأيام ، هدوء لا يقطعه سوى صوت خطواتي ، اتحرك و سكينة غريبة تتبعني و تدفعني للمسير ، كنت أرى أشباح قد لا يراها الآخرين هنا ، كنت أراني بعيداً عني و عن جسدي ، ممسكاً بيد أمي و اتحرك في غفلة عن مستقبل لم أكن أملك – رغم خيالي الخصب – تصور أبسط ما فيه .

حين هممت بتصوير ذاك الجسر ، شعرت ببداية حركة في المكان ، و مع هذا كانت حركة كسول ، رغم نشاط بعض من يتحركون !
كانت كذلك لكونها حركة غير متدفقة أو مستمره ، فقط شخص و يليه آخر ثم سكون ، يمرون كنسمات عابرة تلامس وجهك ، لكنها لا تدفعك للقول بأن الجو فعلاً منعش .

عدت للدرج الكهربائي ، تأملت الساحة الكائنة بالأسفل أمام الدرج ، و تذكرت محلاً و للدقه مكاناً للحلويات ، صُنع أغلبه من مادة ” الفايبر جلاس ” الشفاف و الشبيه بالزجاج ، حيث يُرى ما بالداخل من حلوى ملونة و متنوعة و متعددة النكهات ، كنا نقف لنأخذ كيساً شفافاً و نعبيه من تلك الصناديق ، ثم نضع ما معنا على الميزان و يتم الدفع .
هذا المحل و ضع بالقرب من سلم النزول الكهربائي و الباب رقم ٣ ، لكنه اختفي اليوم و نصب محل آخر ، و أمام البوابة شيد كاونتر خشبي يشبه سفينة لم تكتمل البناء ، جلس في قلبها موظف أمن يرقب العابرين و يرقبونه .

مضيت باتجاه البوابة رقم خمسة ، حيث توجد مكتبتي المفضلة في ذلك الحين “تهامة” ، كانت مختصة بالكتب فقط، و يوجد بها بعض أفلام الفيديو الخاصة بالطفل ، كما كان لها سلسلة مطبوعة من الكتب تحمل شعارها و اغلبها لكتاب سعوديين ، لم تكن مثل جرير مزدحمة بالقرطاسيات أو الدفاتر المدرسية بل كانت مكتبة ثقافية فحسب .

هذا الفرع كان دوماً مضيئ فنوافذه العديدة تطل على شارع العليا العام ، و تتيح مجال للنور أن يدخل فتغدو الأشياء نفسياً لها وقع مختلف .

كما كان يوجد محل لعب ملاصقاً له لا اذكر اسمه ..
لديهم لعبة للأطفال تشبه المسجل ، يوجد بها مكان للشرائط الكاسيت و يلتصق بها مايكروفون ، تستطيع من خلالها التسجيل أو الأستماع .
دخلته ذات مرة مع سيدة محافظة ترافقنا، و لتجريبه أشغل البائع الكاسيت و كانت مقطع لرجل يتأوه ثم يلهث ، و قبل أي أستفسار عن السعر مضت و هي تسحب يدي قائلة ” بلاش قلة أدب ” بينما البائع يودعنا بعيون متسعة !!
ظلت الأغنية في رأسي و حكيت لأصدقاء الصف عنها فأخبروني أنها أحدى أغنيات مايكل جاكسون الشهيرة في ذلك الحين .

أكملت تجولي في السوق التجاري الخالي ، و استنشقت رائحة بن طحن للتو .
كان محل “المهباج” مفتوح الأبواب ، و البائع يجلس بوجه غير بشوش ، لكنه ليس غاضب ايضاً ، دلفت للداخل و سألته إن كانوا يبيعون قهوة تركية جاهزة للشرب ؟

هز رأسه و مضى خلف ستار ، هناك شاهدته يحركها في الركوة و انتشرت رائحتها أكثر ، تجولت داخل محله بينما كانت عيناه محدقة في القهوة ، ابتسمت حين شاهدت زجاجة قهوة نسكافية خالية في الثلاجة و معبأة بالماء ، وضع بها النعناع كي يظل يانعاً ولا يفقد لونه أو رائحته ، فكرت أن أجرب هذه الطريقة في منزلي المرة القادمة عند شرائه .

ايضا وجدت بعض الحلوى التي كانت تباع في ذلك المحل و لكن مغلفة ، كما شاهدت اعلان وضع على ثلاجة آيس كريم بها بشر من جنسيات مختلفة و كتب ” مهما اختلفنا .. ما تختلف الابتسامة ! “

سحبت زجاجة ماء و وقفت انتظره أمام الصندوق ، لامستني كثيراً محاولته في تكييف المكان وفقاً لتركيبته و طبيعته ، الساعة الشرقية على الحائط و المخدة ذات النقوش العربية على المقعد ، حين أتى طلبت منه علبة من علك قديم شاهدته على الرف الكائن خلفه ، كانت اختي تحبه و أحببت أن اشتريه لها .

صعدت ثانية للأعلى و جلست على طاولة في قسم الأطعمة ، أخرجت جهازي و بدأت الكتابة و بدأ الناس بالتوافد ، بعضهم يتناول افطاره قبل العمل ، و بعضهم يحمل ما طلبه و يمضي خارجاً ، غالبية القادمين كانوا من دول أجنبية ، بعض آخر من مواليد الرياض و لا يحملون الجنسية السعودية لكن يتقنون لبس الثياب العربية ، و بعض الفتيات السعوديات اللواتي أخترن الأفطار هنا مبكراً ، بعيداً عن الاجواء المزدحمة و الصخب ، ارتشفت قهوتي ثم تناولت افطار خفيف مثلهم .

في طريقي للنزول كان متجر ” أديم” شرع أبوابه ، دخلت و بعد التحية سألتهم متى فُتح المكان تحديدا ؟ و استأذنت أن أصور القسم الخاص بطلبة “مدارس الرياض” ، فكانت الأجابة أن المحل تم افتتاحه عام ١٤٠٣ هجرية ، الموافق ١٩٨٢ او ٨٣ ميلاديه ، و كان لا يخيط هنا سوى الزي الخاص بطلبة هذه المدرسة ، و لم يمانعوا في التصوير .

سرت خلفه و هو يصطحبني للقسم الخاص بها ، حين وصلنا وقفت أمامها و كأني أقف أمام شخص غريب لا أعرفه ، فالألوان قد تغيرت عن التي أعرف ، و مع هذا و لكونه يقف بجواري صورتها !

حين وصلت للدرج كانت مياه النافورة تنهمر ، و عمال النظافة يغسلون عن الأرض تثاؤبها ، و الخطوات تزيد و الأنوار تضئ ، فتذكرت الأسقف المزينة بحديد مجوف على شكل مربعات ، و بينها و بين السقف توضع اضاءات النيون على اشكال مختلفه ، ليظهر انعكاسها على الأرض اللامعة .

مضيت للرجل الذي يبيع شاي بالحليب المركز قرب بوابة الدخول ، طلبت منه كوب و رأسي يتحرك لمراقبة الناس الذين احيوا المكان و بدلوا من احساسي به ، بدا و كأنه محلاً آخر غير الذي دخلته أول النهار ، يتبادلون السلام و الحديث ، و رائحة العطور تنتشر في الأجواء ، سواء التي استخدمها القادمين او المنبعثة من المحلات التي تبيع البخور و تبيعها .

جلست على أحد المقاعد الخشبية بذهن لا يفكر بشئ ، اشرب ما طلبته و يغمرني احساس مريح ، اشعر بأني لست وحدي و في الوقت ذاته مستمتعاً باني وحدي !

انهيت مشروبي ولم يزل صوت المياه ينهمر كالمطر ، جلست قليلاً لأنهي كتابة مسودة هذا الموضوع ، الذي ادرك بأنه قد طال و تشعب كالذكريات تماما .
أرسلت فى 1980, وطني
الوسوم: فرسان, واحد, المرسم, الرياض, العقارية, اديم, اسواق, تهامة, ثمانينات, جرير, حسام















































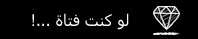






مشاركات وانطباعات واراء الزوار